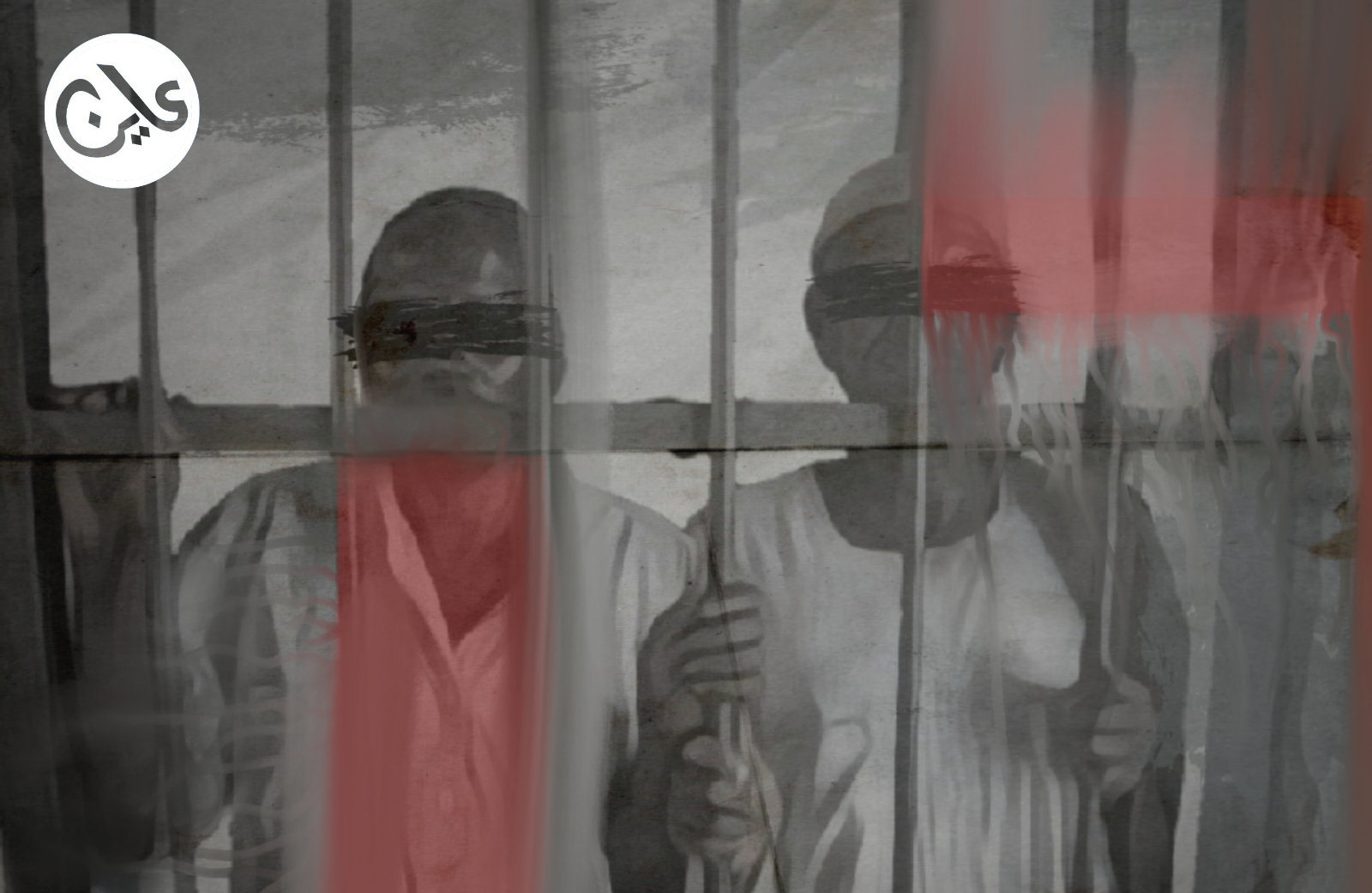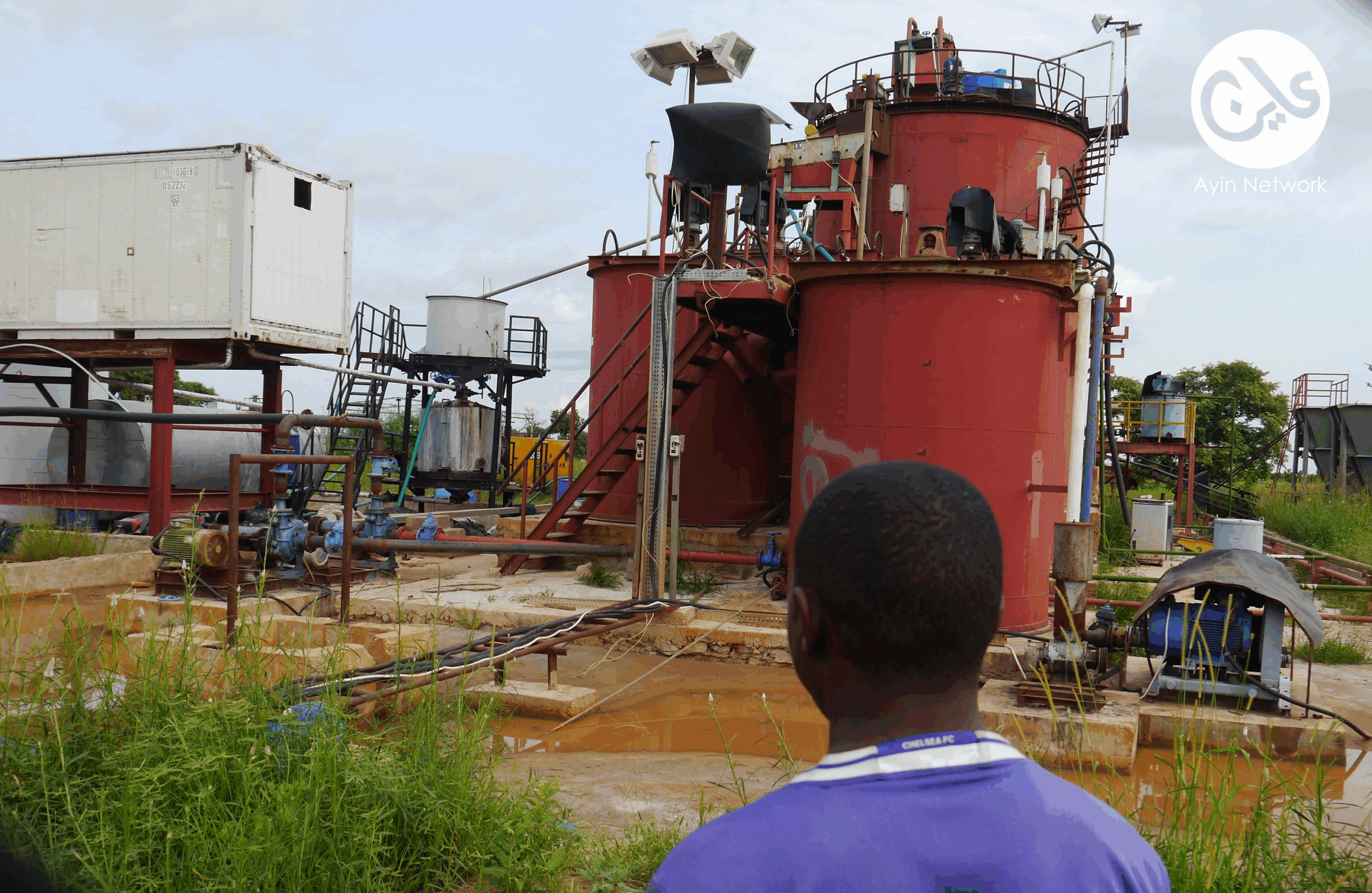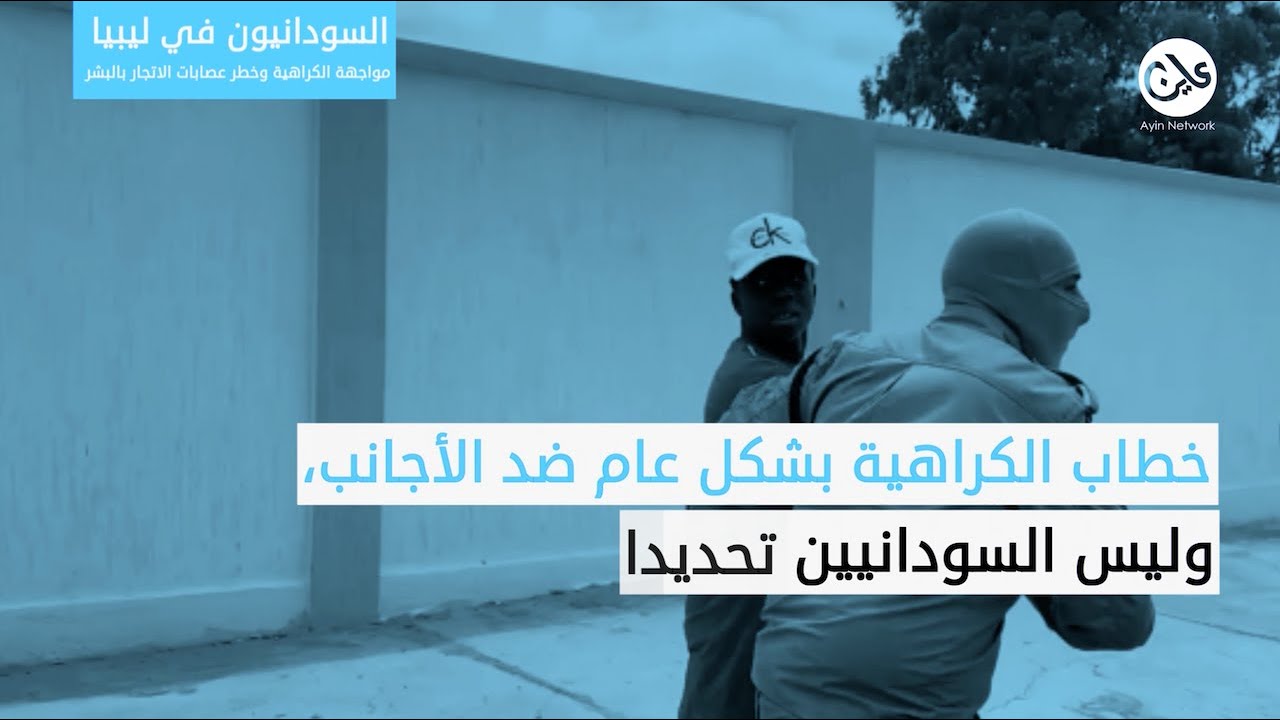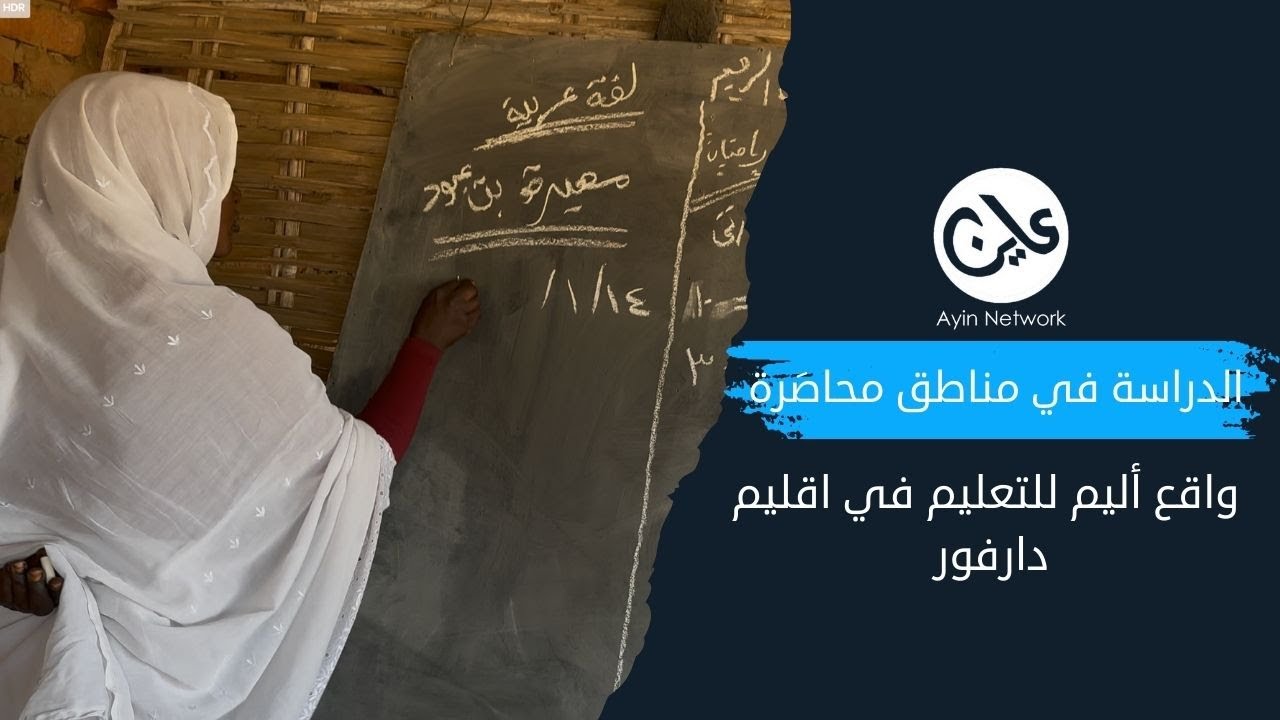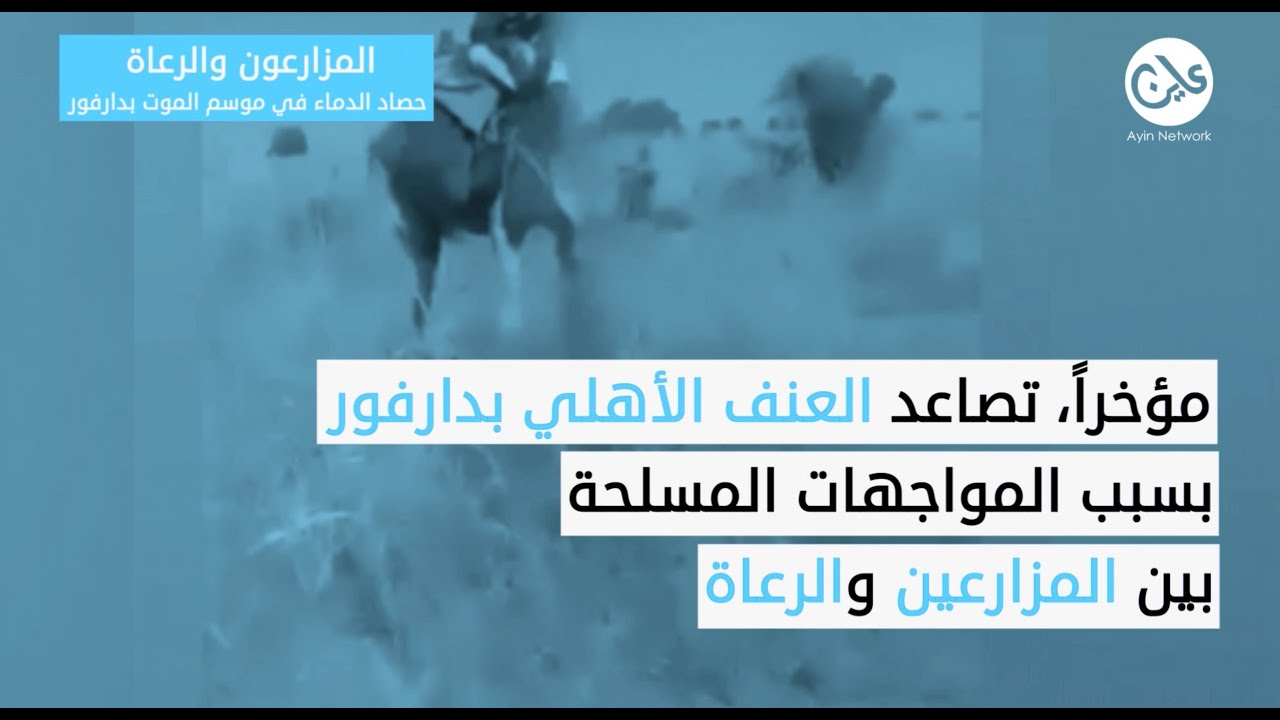السودانيات الحوامل.. مواجهة العنف داخل غرف الولادة
عاين- 27 نوفمبر 2025
ما إن تخطو المرأة الحامل عتبة أي مستشفى للولادة في السودان، حتى تبدأ رحلتها مع “العنف الممنهج” الذي تحول من استثناء إلى قاعدة تدفع آلاف النساء لمخاطرة الولادة المنزلية، وفقا لشكاوى متزايدة من نساء وذويهن، وشهادات عاملين داخل المرافق الصحية، تلقتها (عاين)، فإن غرف الولادة في المستشفيات السودانية تواجه فيها النساء الحوامل العنف اللفظي والجسدي الذي صار جزءاً من “تجربة الولادة” نفسها.
هذا الواقع يدفع عدداً متزايداً من النساء إلى تجنب المؤسسات الصحية، واللجوء إلى الولادة المنزلية رغم مخاطرها العالية، في وقت تشير فيه التقديرات الأممية إلى ارتفاع مضطرد في وفيات الأمهات والمواليد في السودان خلال العامين الماضيين.
تجربة إنجاب طفل في مستشفى حكومي كانت أقرب للعقاب، بعض القابلات يتعاملن مع المرأة أثناء المخاض كما لو كانت مذنبة تستحق الإهانة
سيدة خاضت تجربة ولادة بمستشفى حكومي
“مها عبدالسلام” تصف تجربتها في أحد المستشفيات الحكومية بأنها كانت أقرب إلى “العقاب”. وتشير في مقابلة مع (عاين)، إلى أن بعض القابلات يتعاملن مع المرأة أثناء المخاض كما لو كانت مذنبة تستحق الإهانة. وتقول إنها تعرّضت للضرب والسباب والمطالبة الفورية بالمال في لحظة كانت فيها في أقصى درجات الضعف، ما جعلها تشعر بأن عملية الولادة تُعامَل كجريمة لا كحالة طبية تتطلب الرعاية والدعم.
وتقارن مها، تلك التجربة بما وجدته لاحقاً في مستشفى الراهبات للولادة بالخرطوم، حيث تصف الخدمة بأنها “منضبطة ومحترفة”، يقوم فيها الطاقم بمتابعة الأم والطفل قبل الولادة وبعدها، ويقدم دعماً إنسانياً يخفف التوتر المصاحب للعملية.

وبعد نزوحها إلى ولاية أخرى، تقول مها، إنها “أوقفت أي خطط للإنجاب”، وتشير إلى أن كثيراً من النساء يتجنبن المرافق الصحية الحكومية بسبب ما يسمعن من روايات “قاسية ومقلقة” حول سوء المعاملة ونقص الرعاية. وترى أن هذا المناخ يدفع العديد من الأسر إلى تفضيل الولادة المنزلية رغم مخاطرها العالية، ما يفاقم التهديدات التي تواجه صحة الأمهات والمواليد في ظل التدهور المستمر للخدمات الصحية منذ اندلاع الحرب.
سباب واعتداء بدني
مصطفى التجاني، زوج وأب لطفلين، يصف تجربتي الولادة لزوجته في مستشفى حكومي بأنهما كانتا “قاسيتين ومهينتين” على حدّ تعبيره. يقول لـ(عاين) إن “زوجته تعرّضت في الولادة الأولى للضرب والسباب داخل غرفة الولادة، لكنه لم يدرك حجم ما جرى إلا بعد انتهاء العملية، حين لاحظ (تدهوراً نفسياً واضحاً) لدى زوجته”.
وفي الولادة الثانية، ورغم تغيّر الطاقم، يؤكد مصطفى، أن نمط السلوك بقي كما هو: شتائم، إهمال، وتجاهل، إضافة إلى اعتداء بدني. ويوضح أنه حاول هذه المرة مواجهة الفريق الطبي، لكنه فوجئ – بحسب قوله – بأن العاملين “مدركون لما يحدث ولا يتدخلون”.
ويتحدث مصطفى، عن امتداد الضرر إلى ما بعد الولادة، إذ تحولت إجراءات الحصول على إفادة لاستخراج شهادة الميلاد إلى ما وصفه بـ“جرجرة يومية” استمرت أشهراً، وربط ذلك بموقفه الاحتجاجي على ما حدث داخل غرفة الولادة.
ويرى أن ما تعرّضت له زوجته لا يعود إلى “تصرفات فردية” بل إلى نمط راسخ داخل المستشفيات الحكومية. ويضيف: “المطلوب تدريب وتأهيل حقيقي للقابلات، وأن يتوقف الأطباء عن التغاضي عن السلوكيات الخاطئة، لأن الأم في النهاية هي من تتحمل التكلفة كاملة.”
الكادر الطبي بين الضغط والتقصير
طالبة تمريض شاهدة على الممارسة من داخل غرف الولادة، تكشف في حديثها لـ(عاين)، أن المشكلة ليست استثناءً أو حادثاً عابراً، بل نمطاً متكرراً داخل مؤسسات يفترض أن تكون تعليمية وتدريبية. وتقول نمارق عادل، مساعدة طبيب، إن مشاهد العنف داخل غرف الولادة ليست روايات بعيدة، بل جزء من التجربة اليومية حتى للطلاب في التدريب العملي. تروي أنها درست مادة الولادة عملياً داخل مستشفى حكومي، حيث كان يفترض أن يشاهد الطلاب تطبيق ما تعلموه نظرياً. لكن ما صدمها – كما تقول – لم يكن الجانب الطبي، بل طريقة تعامل بعض القابلات مع النساء.
تشير نمارق، إلى أن الطالبات كن يواجهن صعوبة حتى في طرح الأسئلة، “الداية زهجانة وما بترد”. أما أثناء الولادة، فتصف المشهد بوضوح: صراخ امرأة تتألم، قابلة ترد عليها بألفاظ جارحة، وضرب متكرر على الفخذ لإجبارها على الالتزام بالتوجيهات. تقول: “هذه كانت أول مرة أشاهد كادراً صحياً يتعامل مع مريضة بهذه الطريقة”.
لم تتوقف التجارب عند ذلك. في مستشفى الدايات، وهو مستشفى متخصص في الولادة شاهدت حالات شتائم وعنف جسدي ما زالت عالقة في ذاكرتها، كما تصف. وتقول: حاولت الاعتراض، لكن “لا حياة لمن تنادي”.
تربط نمارق استمرار هذه الممارسات بمنظومة متكاملة من القصور: قانون غير رادع، إدارة ضعيفة، أخصائيون لا يواجهون الانتهاكات، وكوادر طبية تتأقلم تدريجياً مع بيئة عمل منحازة للعنف. كما تحمل جزءاً من المسؤولية للمجتمع، الذي يتعامل مع العنف أثناء الولادة كأمر “عادي”، تتجاوزه النساء بمجرد انتهاء الولادة دون تقديم شكوى.
وتشير إلى جانب آخر مهم نادراً ما يُطرح حسب وجهة نظرها: رسوم إضافية تفرضها بعض القابلات على الأسر بصورة إجبارية، إضافة إلى احتكارهن بعض مستلزمات الولادة داخل العنابر وبيعها بأسعار مبالغ فيها بحجة السرعة وعدم وجود وقت لشراء المستلزمات من الخارج.
وتختم بأن تدريب القابلات لا يجب أن يقتصر على المهارات الفنية، بل يجب أن يشمل تأهيلاً نفسياً على الصبر والتعامل الإنساني، لأن “الممتازات موجودات… لكنهن قليل”.
كنت أعتقد أن الحديث عن العنف ضد النساء أثناء الولادة مجرد مبالغة أو اتهامات ظالمة للقابلات، حتى رأيته بنفسي، ضرب، وسباب بألفاظ نابية، وصراخ يطال الأمهات في أكثر لحظاتهن هشاشة
طبيب نساء وتوليد
يقول الطبيب نادر الطيب إنه كان يظن في البداية أن الحديث عن العنف ضد النساء أثناء الولادة مجرد مبالغة أو اتهامات ظالمة للقابلات، لكن تجربته العملية – منذ أيام التدريب الجامعي وحتى عمله قبل شهرين – كشفت له واقعاً مختلفاً تماماً. مشاهد العنف لم تكن روايات منقولة، بل وقائع عايشها بنفسه: ضرب، شتائم بألفاظ نابية، وصراخ يطال نساء في أكثر لحظاتهن هشاشة. يصف الأمر بأنه “غير إنساني”، ويستغرب كيف أصبحت بعض هذه الممارسات جزءاً من الروتين داخل غرف الولادة.
يشير أيضاً إلى العشوائية في أداء العمل، وضعف الالتزام بالتعقيم والتطهير، مع غياب رقابة فعّالة على القابلات مقارنة ببقية الطاقم الطبي.
ويشبّه نادر – وهو طبيب عمل في مستشفيات حكومية وتعليمية وبعض الخاصة – هذه الممارسات بأنها ليست حوادث معزولة. يؤكد أن العنف اللفظي والجسدي يتكرر في لحظات الولادة تحديداً، بعض أفراد الطاقم يلتزمون الصمت، وآخرون يحاولون التدخل، لكن “التجاوز” – كما يقول – هو السلوك الغالب. ورغم أنه لم يشاهد إجراءات طبية خطرة مرتبطة مباشرة بالعنف، إلا أنه يعتبر أن سوء المعاملة وحده كافٍ لإحداث أذى نفسي وجسدي طويل الأمد.
يحدد الطبيب ثلاثة أسباب رئيسية لاستمرار الانتهاكات: غياب آلية واضحة للشكاوى، ضعف الكادر وضغط العمل، وغياب رقابة فعّالة داخل المنشآت الصحية. أما التدريب، فيصفه بأنه موجود “اسماً”، لكنه غالباً دون المستوى، ولا يغيّر سلوكيات متجذرة في بيئة عمل منهارة.
ويقترح نادر، أن الطريق الأسرع لإيقاف هذه الممارسات يبدأ من تدريب جاد ومكثف للقابلات، ومحاسبة فورية لأي تجاوز. ويشدد على أن البروتوكولات المهنية موجودة بالفعل، لكن المشكل الحقيقي يكمن في بنية النظام الصحي نفسه، حيث تآكلت الرقابة، وضعفت الموارد، وتحوّل الضغط ونقص الكادر إلى جزء من يوميات غرف الولادة.
لكن وبالرغم من هذا يقر الطبيب بأن هناك قابلات محترفات، يلتزمن بالمعايير المهنية، ويمارسن عملاً إنسانياً راقياً، ويمتلكن خبرات عملية تتفوق أحياناً على أطباء مختصين. تأكيده على هذا الجانب يوضح أن المشكلة ليست في المهنة نفسها، بل في تفاوت الأداء داخلها، وانعدام نظام مساءلة واضح.
ضغط العمل وراء العنف
في محاولة لفهم الأسباب التي تقف خلف أنماط العنف اللفظي أو القسوة التي تتعرض لها بعض النساء أثناء الولادة، تحدثنا إلى قابلة عاملة في أحد المستشفيات الحكومية. عند سؤالها عن أسباب القسوة اللفظية أو السلوكيات المسيئة التي تتعرض لها بعض النساء أثناء المخاض، امتنعت من تحديد سبب واحد، لكنها أقرت بوضوح بضغط العمل داخل المستشفيات الحكومية. وقالت في مقابلة مع (عاين): “الضغط موجود… وأحياناً لما تكون الست بتتوجع، أو تكورك بعض القابلات بشوفن إنو في شوية دلع، لكن دا ما مبرر.”
تشرح القابلة أن ارتفاع عدد الحالات وتعقيد بعضها خلال ساعات الذروة يدفع القابلات إلى التوتر، وربما فقدان الصبر. لكنها، رغم هذا الاعتراف، تُصر على أن الضغط لا ينبغي أن يُستَخدم ذريعة لسوء المعاملة، في إشارة إلى وعي داخلي بوجود مشكلة، وإن كان التعبير عنها متحفظاً.
وتؤكد أن هناك دورات وإشرافاً مهنياً، لكنها تتجنب تقييم جودته أو مدى الالتزام الفعلي به، ما يترك السؤال معلقاً حول الفجوة بين اللوائح المكتوبة والممارسة اليومية. وعندما سألناها إن كانت قد شهدت سلوكيات عنيفة من زميلات، جاء الرد: “لا ما شفت… إلا أكون غايبة أو ما حاضرة.”

وتطرح القابلة إجابة عامة عن كيفية الشكوى وإجراءاتها تفيد بأن “أي زول ممكن يشتكي”، دون الإشارة إلى وجود نظام فعّال أو مسار واضح، وهو رد يكشف فجوة بين النظرية والواقع. وحين سألناها ما إذا كانت المشكلة سلوكاً فردياً أم انعكاساً لانهيار أوسع في النظام الصحي، اكتفت بقول إن الأمر “طبيعي في ظل الضغط الذي يتعرضن له القابلات في المستشفيات”، عبارة تشير ضمنياً إلى أن السلوك لم يعد استثناءً، بل أصبح جزءاً من البيئة المؤسسية ذاتها.
في ظل هذا التدهور، ترتفع تقديرات الخطر على حياة الأمهات والمواليد. فقد سجلت «أطباء بلا حدود» في جنوب دارفور وحدها 46 وفاة أمومية خلال ثمانية أشهر من عام 2024، وقع 78% منها خلال أول 24 ساعة من وصول الأم للمستشفى، إضافة إلى 48 وفاة لرضّع حديثي الولادة بسبب العدوى، فقبل الحرب كان المعدل الوطني لوفيات الأمهات مرتفعاً أصلاً (نحو 256 وفاة لكل 100 ألف ولادة) حسب تقديرات الأمم المتحدة، لكن الصراع دفع بالنظام الصحي إلى حافة الانهيار. وبحسب وزارة الصحة (أغسطس 2025)، خرج 70% من المستشفيات والمراكز الصحية في الولايات المتأثرة عن الخدمة، بينما أشارت تقارير دولية إلى توقف نحو 80% من المرافق الأساسية في مناطق الاشتباكات أواخر 2024، البيئة التشغيلية نفسها باتت خطرة، إذ وثّقت منظمات دولية نحو 100 اعتداء على منشآت طبية منذ بداية الحرب، كما أدت انقطاعات الكهرباء إلى وفيات بين حديثي الولادة، بينها وفاة 6 رضع خلال أسبوع واحد في شرق دارفور بسبب نقص الأكسجين. ومع غياب الإمدادات وتكرار النهب، اضطرّت آلاف النساء للولادة في المنازل أو مع قابلات غير مؤهلات.
عنف ممنهج وحماية مفقودة
في سياق تتبّع أنماط العنف داخل غرف الولادة في السودان، يُظهر حديث الناشطة النسوية ومديرة البرامج في منظمة نورا، حواء دهب، لـ(عاين)، صورة متماسكة عن مشكلة تتجاوز الأفعال الفردية لتصبح سلوكًا مؤسسيًا راسخًا. وتقول: “العنف داخل المؤسسات الصحية أو داخل غرف الولادة لا يمكن أصلًا تصنِّيفه كـ انتهاك فردي، لأن هذا التصنيف بيختزل المشكلة في أفراد، بينما الواقع أنه سلوك منتشر في كل السودان.”
السلوك الذي تشير إليه دهب، لا يقتصر على الصراخ أو الإهانة، بل يمتد إلى الضرب، الإهمال، وانعدام الخصوصية داخل العنابر التي تضم أحيانًا أكثر من عشر سيدات في ظروف غير إنسانية. وفقًا لحديثها، فإن المنع المتكرر للمرافقة – والسماح أحيانًا مقابل رشاوى – يضاعف الضغط النفسي على النساء، بينما تعكس ثقافة العمل داخل بعض المرافق الطبية رؤية قديمة للمرأة باعتبارها “موضوعًا للسيطرة”، لا مريضة تمر بتجربة حسّاسة تستوجب الرعاية المهنية.
تفتح حواء نافذة على ما تسميه “العنف الممنهج”: فقدان الرقابة، غياب آليات الشكاوى، وتطبيع المجتمع لسلوكيات القابلات. تذكر أن الإهانة، الصراخ، والسخرية من ألم المرأة تحولت إلى ممارسة يومية، وأن كثيرًا من النساء لا يبلغن بسبب عدم الوعي بأن ما حدث لهن انتهاك، أو خوفًا من الانتقام، أو لأن النظام نفسه لا يوفّر قنوات آمنة للتبليغ. وتروي مثالًا لطفلة توفيت بعد شهرين من إصابة أثناء الولادة لم ينتبه لها الأهل إلا بعد مغادرة المستشفى، لتكشف القصة انهيار المتابعة الطبية وغياب الاشتراطات المهنية.
ترى حواء دهب، أن الحرب وتدهور القطاع الصحي عمّقا جذور المشكلة: خمس قابلات قد يستقبلن أكثر من ثلاثين حالة يوميًا، وهو ضغط يُنتج بالضرورة عنفًا لفظيًا وجسديًا، بينما يدفع نقص الأدوية والكوادر والمعدات النساء إلى الولادة دون أدنى شروط السلامة. في وصفها: “هذا نمط ممنهج أكثر من كونه أفعال أفراد.”
وتؤكد أن الإصلاح يبدأ من إعادة بناء العلاقة بين المرأة والمؤسسة الصحية عبر “مدونة حقوق للنساء أثناء الولادة” تكون معلّقة بوضوح في كل مستشفى، تشمل الحق في الاحترام، الخصوصية، الموافقة، ورفض أي سلوك مهين. وتضيف إلى ذلك ضرورة توفير آلية شكاوى سرية وفعّالة تُنهي ثقافة الإفلات من المحاسبة، وتعيد تعريف تجربة الولادة كعملية إنسانية يجب ألا تُختزل في معادلات الضغط والتهديد، بل في بيئة تحترم كرامة النساء، وتمنحهن أمانًا مهنيًا ونفسيًا.
الصمت يعزز مشروعية تلك التصرفات
في السياق القانوني حول العنف داخل غرف الولادة، تقدّم المحامية سلوى أبسام قراءة تُظهر حجم الفراغ التشريعي الذي يترك النساء دون حماية فعلية. فالقانون السوداني، كما توضح، في حديثها لـ(عاين) لا يعترف بفئة مستقلة تُسمّى “العنف أثناء الولادة”، بل يدمجها ضمن الإساءات العامة الواردة في القانون الجنائي لعام 1991. وتشير إلى أن المادة (160) – التي تُجرّم الإهانة اللفظية – هي الأقرب لوصف هذه الحالات، لكن النص نفسه يضع عبئاً ثقيلًا على الضحية، إذ يعتمد على إثبات “القصد”، وهو عنصر معنوي يصعب توثيقه في غرف مكتظة وتحت ضغط حالات طارئة.
تشير المحامية أبسام: إلى إن هذا الغياب للنصوص الصريحة جعل المسألة مرتهنة تمامًا لاجتهادات مهنية وأخلاقية، وهي ضوابط لا تعمل في ظل الانهيار المؤسسي وضعف الرقابة. تعطي مثالًا على نوع المسؤوليات: القابلة تُحاسَب مباشرة أمام القانون الجنائي، بينما تُلزم المستشفى بالتعويض وفق مبدأ “التابع والمتبوع”، وفي حالة المؤسسات الحكومية فإن وزارة الصحة تتحمل المسؤولية النهائية. هذا التعقيد القانوني يوضح أن المساءلة ليست مستحيلة، لكنها غير مُفعّلة في كثير من الحالات.
ورغم تعدّد مسارات الشكوى – من إدارة المستشفى، إلى المجلس القومي للمهن الطبية والصحية، إلى المجلس الطبي في حالة الأطباء، وصولاً إلى النيابة العامة والدعاوى المدنية – إلا أن فعاليتها تظل محدودة. السبب، كما تُجمله المحامية أبسام، يعود إلى ضعف الوعي بحقوق النساء، وصعوبة الإثبات، وقلق كثيرات من الدخول في إجراءات مرهقة بعد الولادة. وتقول: “الصمت يعزز مشروعية تلك التصرفات… وتشجيع تقديم الشكاوى أصبح ضرورة، لا خياراً.”
بهذه القراءة، تكشف سلوى أن المشكلة ليست فقط في ممارسات خاطئة داخل غرف الولادة، بل في بنية قانونية لا توفر حماية كافية، ما يجعل الإصلاح مرتبطًا بإعادة تعريف العنف التوليدي في القانون، ووضع آليات واضحة وسهلة تضمن للنساء حق المساءلة دون خوف أو تعقيد.